
لعلنا لا نبالغ في الوصف إن قلنا إن البشرية لم تنشغل على مر تاريخها بأمر كانشغالها بموضوع (الأسرة).
ذلك الكيان الاجتماعي العظيم الذي يجتمع في ظلاله الزوجان، وينهل من سواقيه الأبناء، وتترابط عبر وشيجته الشعوب والجماعات.
فالأسرة هي الوحدة الأولى في بناء المجتمع، وهي قلب المجتمعات النابض التي إن صلحت صلح سائر الجسد، وهي الرحم الثاني الذي يتشرب فيه الأفراد قيم المجتمع وثقافته، وفي ظلها يتلقى الوليد أساسيات العلوم التي تفسر له ما يحيط به من مظاهر الحياة، ويتعلم خلالها جملة الحقوق والواجبات تجاه نفسه وأهله ومجتمعه والناس أجمعين، فيخرج من بعد ذلك خلقا من بعد خلق، ولذا فقد اعتنى الإسلام بالأسرة عناية بالغة، ورسم لها عبر كل مراحل تكوينها وتطورها منهجا ربانيا شاملا، وسن لها من الأحكام ما يصاحب كل أطوار نموها، وفرض على المجتمع المسلم واجبات لبنائها ونمائها، راسما لها أهدافها، ومؤسسا لقواعدها، ومحددا لطبيعة العلاقات التي تربط أفرادها بعضهم ببعض.
ولما كانت الأسرة على هذا النحو من الأهمية والتأثير فقد حظيت بعناية كل مصلح، بل انتقل الاهتمام بالأسرة والعناية بها من دائرة الشأن التربوي التنموي المجرد إلى دائرة أمن الدول والأمم والحضارات، لأن أي خلل يطرأ على هذا الصرح المهم يؤدي لخلل عام، ويفضي لفساد متعد يصيب جسد المجتمعات إصابة قد يقصر دونها تداعي سائر أعضائه بالسهر والحمى.
والأسرة "كوحدة اجتماعية" لا تعيش في فضاء منقطع عن غيرها من مكونات المجتمع والدولة، فهي تؤثر وتتأثر بكل ما يحيط بها من بيئة ثقافية، أو تربوية، أو اجتماعية، ولهذا كانت على مر التاريخ مناط اهتمام المصلحين والمفكرين والساسة، مما دفع بعضهم إلى محاولة توظيف هذا الكيان والهيمنة على مكوناته، وتوجيهها فيما يخدم تطلعات الدول ومطامع الساسة.
وقد شهدت هذه الحقبة التاريخية التي نعيشها تهديداً خطيراً لهذا الكيان تمثل في تقويض الدعائم الأخلاقية والدينية التي تتأسس عليها الأسرة، فتسربت لهذا المحضن القيم المادية، حتى باتت الأسرة عند بعض المجتمعات الغربية مجرد محضن مؤقت، أو بلغة أخرى "آلات تفريخ" تقدم فيه الرعاية للوليد الجديد بشراكة كاملة بين الدولة والوالدين، إلى أن يبلغ الولد سن التكليف التي تبيح له الانقطاع عن هذه الشجرة، ليهيم بعد ذلك على وجهه، ويشق طريقه في الحياة بحرية تامة.. لا يكاد يذكر هذا الرباط إلا في بعض الأعياد والمناسبات، أو إذا حل أجل تقاسم الإرث الذي خلفه أحد الأبوين أو كلاهما.
ولا يخفى على كل مراقب لمسيرة وجود الجاليات المسلمة في الغرب أنها انتقلت من مرحلة الوجود الطارئ المؤقت إلى مرحلة التوطين -بل المواطنة- وتنامي هذا الوجود سواء على الصعيد الطوبغرافي، أو على صعيد التأثير والتأثر الثقافي.
وقد صاحب هذا التطور والنمو العديد من التحديات والصعوبات، كان على رأسها وفي مقدمتها -دون منازع- شأن الأسرة المسلمة، وكيفية الحفاظ على هذه الشجرة الطيبة المباركة، والجمع بين الإبقاء على هويتها وقوامها وبين غرس جذورها في تربة مغايرة، ومد جذوعها في فضاء ثقافي واجتماعي آخر، حتى تؤدي دورها، وتؤتي أكلها بإذن ربها في كل حين.
ولقد تضافرت جهود المؤسسات الإسلامية العاملة على الساحة الأوروبية على حمل هذا الملف، ومعالجة هذا الهم، فألفت الكتب، وعقدت المؤتمرات، ووضعت الخطط والبرامج لتحقيق هذا الهدف، ومقاربة هذه المعادلة التي اختصرها بعضهم بقوله: "محافظة بلا انغلاق، واندماج بلا ذوبان".
وكان على رأس هذه المؤسسات الأوروبية رائدها الناصح، وخبيرها المحنك "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، والذي ينطوي تحت مظلته الكبيرة أكثر من ثمانية وعشرين قطراً أوروبيا، وعشرات المؤسسات والمراكز الإسلامية الممتدة على طول الساحة الأوروبية شرقا وغربا، وقد نص دستوره وميثاقه على أولوية العناية بالفرد والأسرة المسلمة على حد سواء، ووضع من البرامج والخطط ما يكفل العناية بهذا الملف المهم، حتى لا يغيب عن بال قادة العمل الإسلامي في خضم أعمالهم اليومية ومشاغلهم المتراكمة، وقد قررت قيادة الاتحاد أن يكون ملف "الأسرة المسلمة" هو ملف عام 2009، ووضع جملة من المحاور التي تخدم هذا الملف والتعريف به، ومعالجة مواضيعه المتعددة.
وهذا نداء ودعوة لكل من يقرأ هذا البيان، كي يضم جهده لجهد العاملين، ويتقدم بنصحه وإرشاده للقائمين على مشاريع هذا الملف، حتى يصل نفعه لجمهور المسلمين في أوروبا، ويصيب خيره كل متابع لهذا الأمر، فمن فاتته المشاركة لعذر فلا أقل من حيازة الثواب والأجر.


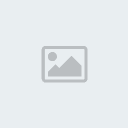
 شكرااا على مروركم + في انتظار ردودكم ارجوا ان لا تخدلوني
شكرااا على مروركم + في انتظار ردودكم ارجوا ان لا تخدلوني